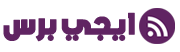هل النسوية “فكرة غربية صُنعت لتدمير مجتمعاتنا”؟

كثيراً ما تُتهم النساء العربيات اللواتي يدافعن عن أفكار يعتبرها البعض “ليبرالية” ويطالبن بحقوق الإنسان الأساسية، وكذلك منظمات حقوق المرأة في المنطقة العربية، بـ”استيراد المفاهيم الأجنبية التي نشرها الغرب بيننا وزرعها في عقولنا لتدمير مجتمعاتنا وتفكيك الأسرة”.
ومن خلال هذه التعليقات على منشورات “النسوية” على وسائل التواصل الاجتماعي، يحذر المعلقون من تأثير “الأفكار النسوية” على عائلاتنا – وهو تحذير يأخذ في كثير من الأحيان شكل اتهام خطير.
ولكن هل هناك أي أساس تاريخي يدعم مثل هذا الاتهام؟
ماذا نعرف عن تاريخ الحركة النسوية في العالم العربي؟ هل هو مختلف مفهوميا عن التجربة الغربية؟

“اتهام” النسوية
وتقول لينا عاشور، الأستاذة المساعدة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، إن نية هذا الاتهام تختلف وتعتمد على الفرد ودوافعه السياسية.
برأيها فإن هدف الاتهام القادم من شخص من العالم العربي هو “تشويه أي أفكار نسوية ونسبها للغرب، وتصوير الذات على أنها وطنية والحفاظ على القيم الوطنية من خلال نسب هذه الأفكار إلى مكان آخر”.
ولكن عندما تأتي هذه الاتهامات من غربي يدعي أن النسوية مفهوم غربي حصري، “فإن الهدف مختلف تماما لأنه ينظر إليه على أنه عنصرية محضة”، بحسب عاشور.
وتوضح أن ذلك يعود إلى فكرة لدى بعض الغربيين بأن الشعوب العربية «رجعية وتفتقر إلى الأفكار التقدمية».
بالاشتراك مع لينا عاشور، المتخصصة في نظرية النوع الاجتماعي ودراسة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، تحدثت مع سارة مراد، مؤسسة ومديرة مشاركة لبرنامج دراسات المرأة والنوع الاجتماعي في الجامعة الأميركية في بيروت.
يتفق مراد وعاشور على أن فكرة ارتباط النسوية بالغرب تدحضها حقيقة أن العديد من الأفكار والحركات النسوية في المنطقة العربية عبر التاريخ ارتبطت بالحركة المناهضة للاستعمار التي جاءت إلى منطقتنا وبحركات النضال الوطني، وليس العكس.
ويعلق عاشور قائلاً: “من الملائم جدًا للمتشككين أن ينزعوا الطابع السياسي عن التاريخ ثم يزعموا أن النسوية مستوردة من الغرب”.
هل هناك مشكلة في التعريف؟

تُعرّف الموسوعة البريطانية مصطلح “النسوية” على أنه “الاعتقاد بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الجنسين”.
بحسب الموسوعة: “على الرغم من أن الحركة النسوية نشأت في الغرب بشكل رئيسي، إلا أنها تنتشر في جميع أنحاء العالم، ويمثلها مؤسسات مختلفة مخصصة للدفاع عن حقوق ومصالح المرأة”.
ومع ذلك، قد يجد بعض خبراء النوع الاجتماعي والنسوية هذا التعريف غير دقيق لعدة أسباب وتفاصيل مختلفة.
على سبيل المثال، تقول عاشور إن أحد أهم الفروقات بين “النسوية الليبرالية الغربية” وتاريخ النسوية في العالم العربي هو أن التفسير الغربي للنسوية يركز عادة على قضية واحدة فقط ويناقشها: الجنس. ومن ناحية أخرى، كانت النسوية في العالم العربي أكثر شمولاً على الدوام، “حيث لم تنفصل الأفكار النسوية في المنطقة قط عن المطالب الاجتماعية والسياسية الأخرى بالحقوق”.
وتضيف: “عندما نحاول توثيق أعمال المفكرات النسويات العربيات المشهورات ومقارنتها بنظيراتهن في الغرب، نشعر وكأننا لا نملك الكثير من الأرقام مقارنةً بالغرب. لكن هذا في الواقع غير صحيح”.
وتشير عاشور إلى أن العديد من المفكرات والناشطات والعاملات والناشطات العربيات كن “نسويات” تلقائياً، لكنهن لم يحددن أنفسهن على هذا النحو، أي أنهن لم يستخدمن مصطلح “نسويات” للدلالة على هويتهن الفكرية، مما يجعل من الصعب العثور عليهن في البحث عبر التاريخ.
وتشير عاشور أيضًا إلى فرق آخر في الطريقة التي تمارس بها الحركة النسوية في العالم العربي والغرب.
وتقول إنه في العالم العربي “ليس لدينا نفس النهج (للنضال)، وهو أن يكون لدينا شخصية رئيسية” تعمل كزعيمة وحيدة لحركة نسوية.
ويشير أيضاً إلى نقص التخصص الأكاديمي في هذا المجال في العالم العربي.
تعتبر الطبيبة والمفكرة المصرية نوال السعداوي واحدة من أبرز وأشهر الكاتبات والمفكرات النسويات العربيات، لكن هذا ليس تخصصها الأكاديمي ولا مجال بحثها، “وهذا ليس مهما حقا”، كما تقول عاشور.
وفي لبنان، قُتلت وردة بطرس، وهي عاملة كانت تتظاهر للمطالبة بزيادة الأجور. لم تقدم وردة بطرس ولا رفيقاتها أنفسهن باعتبارهن نسويات، ولكنهن كن كذلك.
وكانوا من بين العاملين في مديرية التبغ والتنباك اللبنانية التي تأسست سنة 1935 في عهد الانتداب الفرنسي. شاركوا في المظاهرات والإضرابات العمالية عام 1946 للمطالبة بزيادة الأجور وغيرها من الحقوق العامة، بما في ذلك حقوق النساء العاملات في المنشأة. وأطلقت قوات الأمن النار عليهم.
كيف بدأ كل شيء؟

تحاول سارة مراد من الجامعة الأميركية في بيروت رسم صورة لبدايات المعلومات المتوفرة لدينا عن النسويات العربيات، وتعود بنا إلى أواخر القرن التاسع عشر.
أخبرني عن اللبنانية زينب فواز؛ وكانت كتاباتها المنشورة من أوائل الكتابات التي وصلتنا من المفكرات والكاتبات النسويات العربيات.
وتقول: “تشير بعض المصادر إلى أنه حوالي عام 1892 نشرت زينب فواز مقالات في الصحف المصرية تدافع فيها عن حق المرأة في التعليم والعمل”.
ويشير مراد أيضًا إلى مي زيادة، التي ولدت في الناصرة من أب لبناني وأم فلسطينية.
وفي وقت لاحق، كتبت مي زيادة ثلاث قصص على الأقل عن حياة نساء أخريات أقل شهرة، مع التركيز على حياتهن وإنجازاتهن. وكانت هذه القصص بمثابة سجلات لعصور معينة، وكأنها موسوعة لإنجازات المرأة التي لم يلاحظها أحد.
صدر كتاب “مستكشفة الصحراء” للكاتبة مي زيادة عام 1920، والذي يحكي قصة حياة الكاتبة المصرية ملك حفني ناصف.
تقول عاشور بدورها: “يمكن اعتبار ملك حفني ناصيف من أوائل النسويات في مصر أواخر القرن التاسع عشر، لأنها كتبت عن حقوق المرأة. ومع ذلك، لا أستطيع القول إن ملك حفني ناصيف كانت أول نسوية عربية”.
حاول مركز المعرفة للمجتمع المدني في لبنان توثيق تسلسل زمني أولي للمفكرين النسويين في البلاد.
يبدأ السجل في عام 1906 مع لبيبة هاشم، التي يصفها المركز بأنها “واحدة من أوائل الرائدات في لبنان في إصدار المجلات النسائية”. ظهرت مجلتها “فتاة الشرق” بين عامي 1906 و1929 (ترجع بعض المصادر تاريخ النشر الأول إلى عام 1900).
دافع هذا المنشور عن تحرير المرأة وحقها في التعليم والمشاركة السياسية.
ويشير عاشور إلى العديد من التفاصيل التي تؤثر في كيفية وصول هذه الأفكار إلينا.
وتشمل هذه التفاصيل الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص، وقدرته على تحقيق مستوى معين من التعليم، وقدرته على نشر الأفكار في المجلات أو الصحف أو الكتب بحيث تصل إلى الأجيال القادمة.
وترى عاشور أيضًا أن العديد من الأسماء غالبًا ما يتم تجاهلها لأسباب سياسية، حيث أن معظم المفكرين النسويين في العالم العربي كانوا يساريين.
وتضيف: “خلال الحرب الباردة، قامت الحكومات الجديدة في المنطقة بسجن الاشتراكيين، كما عانت النساء أيضًا من الظروف السياسية في ذلك الوقت”.
وتعتقد أيضًا أن بعض النساء “يتم تجاهلهن بسبب نضالهن المسلح، مثل الفلسطينية ليلى خالد”، التي “يمكن رؤيتها في مقاطع فيديو تقدم العديد من الأفكار النسوية في ورش العمل”.
وتضيف: “لهذا السبب أعتقد أنه لا يمكن دراسة الحركة النسوية في المنطقة فحسب، بل يجب أيضًا دراسة تاريخ الحركات السياسية بشكل عام”.
ليلى خالد، أسيرة فلسطينية يرتبط اسمها بعدة عمليات نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أهمها اختطاف طائرة مدنية إسرائيلية ومحاولة اختطاف ثانية.
أشهر الأفكار النسوية العربية
تتميز النسوية العربية بأفكارها الموجهة نحو الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتنوعة في المنطقة ومجتمعها. أي من هذه الأفكار هي الأكثر أهمية؟
1) “فضح النسوية العنصرية”
وترى الأستاذة الجامعية لينا عاشور أن أول مفكرة معروفة ناقشت هذه الفكرة هي الكاتبة والباحثة الاجتماعية المغربية فاطمة المرنيسي، التي بحثت في العلاقة بين النسوية والإسلام.
وتوضح أن المرنيسي وكثيرات غيرها بعد ذلك قلن للنسويات الغربيات: “أنتم أيضًا مقيدون بمبادئ الجمال وتحت ضغط الظهور والتصرف بطريقة معينة بدلاً من الآخرين”. وبذلك، انتقدوا النظرة الغربية التي تعتبر المرأة العربية “خاضعة” بسبب ارتدائها الحجاب وغيره من المحرمات الاجتماعية.
ولذلك، يرى عاشور أن “الغرب يفكر في المرأة وحقوقها في سياق المجتمعات الغربية فقط. وهذا النهج محفوف بالعنصرية وكراهية الإسلام وكراهية المسلمين”.
وتوضح قائلة: “يمكن أن تتأثر قضايا النوع الاجتماعي والنسوية بالسياق (الاجتماعي والديني) ويجب أن يكون هناك مجال للمناقشة والتفاوض”.
2) المرأة العربية “لا تحتاج إلى إنقاذ”

وترى عاشور أن أحد أهم مساهمات النسويات العربيات هو تحدي بعض الأفكار النمطية السائدة عن المرأة العربية والتي تتبناها الحركة النسوية العربية حول الرجل الأبيض.
يشير مصطلح “الرجل الأبيض” إلى نظرية تعود جذورها، حسب المؤرخين، إلى عصر الاستعمار والإمبريالية الأوروبية والتي تبرر هيمنة البيض وتفوقهم العنصري.
وتستشهد بمثال من كتابات ليلى أبو لغد، وهي أمريكية من أصل فلسطيني متخصصة في الأنثروبولوجيا والدراسات النسوية.
وناقشت أبو لغد وجهة النظر الغربية التي تنظر إلى النساء المسلمات على أنهن “لا صوت لهن وضعيفات”، “وليس هذا فحسب، بل إنهن بحاجة أيضًا إلى الإنقاذ من البيض، بما في ذلك النساء البيض”.
وتشير عاشور إلى أن هذه الفكرة “لا تزال دون أي منازع في الغرب الليبرالي وكذلك في العالم النسوي الأبيض”.
3) “لا يمكن فصل القمع الجنسي عن القمع السياسي”.
وكما تشير سارة مراد، فإن تكنولوجيا الطباعة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مكنت النساء من أن يصبحن محررات للمجلات والصحف النسائية.
وبحسب مراد، فإن هذه الإصدارات، التي ظهرت بشكل خاص في مصر ولبنان، أدت إلى ظهور “خطاب نسوي أصيل ودائم” في العالم العربي، وخلق “تبادل ثقافي نسوي واسع النطاق” بين البلدين.
وفي مؤتمر المرأة العربية الفلسطينية الذي عقد في القدس عام 1929، والمؤتمر الأول للمرأة العربية الذي عقد في دمشق عام 1930، ومؤتمر الاتحاد النسائي العربي الذي عقد في القاهرة عام 1944، زعمت النساء العربيات أنه “لا يمكن مناقشة الجنس وحقوق المرأة دون مناقشة الطبقة والإمبريالية والقومية والاستقلال”، كما تتذكر عاشور.
وتضيف: “لم تفصل هؤلاء النساء الأمور في أي وقت من الأوقات ويقولن إنهن يرغبن فقط في التحدث عن قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة”.
لقد أدركوا أن القمع الذي يتعرضون له “كان مرتبطًا بالإمبريالية، وحتى يتخلصوا من الإمبريالية، لن يتمكنوا من التخلص من أي شكل آخر من أشكال القمع”.

4) أهمية التضامن الإقليمي
وتقدم المحاضرة الجامعية في لندن مثالاً لكيفية تجاوز بعض الناشطين حدودهم للدفاع عن حقوق الآخرين. وهذا ينطبق بشكل خاص على ليلى فخرو، البحرينية التي شاركت في الانتفاضة في ظفار في سلطنة عمان.
بين عامي 1963 و1975، شهدت سلطنة عمان واحدة من أهم الصراعات المسلحة الصامتة في الحرب الباردة: بين القوات المسلحة للسلطان بقيادة بريطانيا وحركة ماركسية مسلحة متمركزة في منطقة ظفار الجنوبية.
وفي ستينيات القرن الماضي اندلعت “ثورة ظفار” في منطقة قبلية ضيقة، حيث تأسست خلالها جبهة تحرير ظفار ضد حكم السلطان سعيد بن تيمور.
تخبرنا عاشور أن فخرو استخدمت اسمًا مستعارًا، فبالنسبة لها كان عملها على الأرض “أعلى أشكال النضال”.
وتشير إلى أن مفهوم التضامن والتعاون الإقليمي لتحقيق نتائج فعالة “كان موجودًا في العالم العربي منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي”، بينما “كان متداولًا في الفكر النسوي الغربي كمفهوم غربي تقدمي منذ الستينيات والسبعينيات”.
وتضيف عاشور أنه عندما سُئلت عن مسؤوليتها تجاه عائلتها والمسافة التي تحافظ عليها منهم كمقاتلة، أجابت فخرو: “أؤمن بما أقوم به إلى حد كبير لأنه يتعلق بصحة ورفاهية الجميع، وبهذا المعنى فهو أهم من مسؤوليتي تجاه عائلتي”.
وفي نهاية المقابلة، أشارت عاشور إلى أن العديد من النساء يناضلن من أجل حقوقهن سراً، في مجموعات صغيرة جداً، “ولكن لأسباب أمنية، لا نسمع عن ذلك، وهذا أمر جيد”.
وتضيف: “أعتقد أن هذا الجزء مهم للغاية لأن فكرة الحديث فقط عن الأحداث الكبرى في التاريخ وعدم تكريمها هي أيضًا فكرة يهيمن عليها الذكور إلى حد كبير”.